
تنوَّعت أدوات التكنولوجيا الرقمية: ميتافيرس، وذكاء اصطناعي، وبيانات ضخمة وغيرها؛ ممَّا امتدَّ استخدامه في مجالات شتَّى، من بينها الرعاية الصحية، وأمست تطبيقاته واقعًا مُشاهَدًا في صروح طبيَّة عربية وغربية.
فالميتافيرس أو (العالم الماورائي) على تعدُّد تعريفاته، يمكننا أن ننتقي منها ما قيل بأنه: عالم افتراضي يَدمج العالمين الرقمي والواقعي؛ يتكوَّن من بيئات رقمية ثلاثية الأبعاد، يُمكِّن المستخدمين من التفاعل معها.
ولاستخدام الميتافيرس في مجال الرعاية الصحية فوائد ومميزات جمَّة: كتحسين الوصول للخدمات الصحية، وتوفير التدريب للمهنيين، وتعزيز جودة التدريب الطبي وفعاليته، وتحفيز التجارب العلاجية المبتكرة في بيئات آمنة، وتقليل المخاطر.
ولمَّا كان تلبية احتياجات الدعم القانوني -بشقَّيْه التشريعي والقضائي- تُمثِّل واحدة من أبرز التحديات التي تواجه دخول معطيات الميتافيرس على قطاعات المنظومة الصحية؛ فمن المهم أن يُستهلَّ الحديث ببيان مجالات الأدلة العملية الموضحة لكيفية استخدام الميتافيرس في مجالات الرعاية الصحية، يوازيه في المقام ذاته عرضٌ لأبرز القضايا القانونية المترتِّبة على ذلك، توضيحًا للفكرة بتسلسل في ذهن القارئ؛ نظرًا لتشعب صور هذه القضايا القانونية المحتملة، مع الاعتراف ببقاء هذه الأخيرة قابلة للزيادة.
أبرز التحديات
أولًا: العلاج النفسي عن بُعد (Teletherapy): وذلك باستخدام الميتافيرس في علاج الاضطرابات النفسية؛ كالقلق والرهاب، من خلال التعرض التدريجي للمواقف المخيفة في بيئة آمنة.
وهذا يردنا لاحتمالية إثارة قضايا متعدِّدة، على رأسها: تلك المتعلقة بالخصوصية والوضع القانوني إذا فشل المعالج النفسي في التعامل؟ وعلى من ستقع المسؤولية القانونية؟ وأبعد من ذلك وكنتائج واقعية محتملة: إذا انقطع الاتصال أثناء جلسة علاج حيوية، وأدَّى ذلك لحدوث أضرار نفسية للمرضى أو مضاعفتها، من سيُقيِّم العواقب القانونية؟
ثانيًا: إدارة السجلات الطبية باستخدام الميتافيرس: وذلك لأغراض تخزين أو إدارة سجلات طبيَّة معينة، وسيكون منطقيًّا حينئذٍ السؤال: كيف يمكن ضمان بقاء تلك السجلات مؤمَّنة؟ وماذا لو تم تسريب بيانات طبية لمريض بعينه، أو وقع اختراق أو سوء استخدام أو بيع لنظام البيانات في الميتافيرس؟ وهل تختلف قواعد مُساءلة مقدمي الخدمة، إذا كان مقدمها منصة طبية أو غيرها؟
ثالثًا: التشخيص والعلاج الجراحي عن بُعد Remote Surgery: وذلك في حالة إجراء جراحات عبر الميتافيرس؛ كالجراحة الروبوتية (التي يتم التحكم فيها عن بُعد عبر تقنيات الواقع الافتراضي)، والتي يُسمح فيها بتكرار الإجراءات وتعلُّم الأخطاء دون المخاطرة بحياة المرضى؛ فهذا وإن كان أحد مزايا استخدام الميتافيرس في المنظومة الصحية، إلا أنه لا يعفي من تشعب التساؤلات القانونية.
وبطبيعة الحال، فقضايا هذه الفكرة تحديدًا متعدِّدة ومتوقَّعة، ومنطقية ودقيقة؛ ومن ذلك: التساؤل الأوَّلي عن أبعاد مسؤولية الأطباء عن الأخطاء الطبية أو المضاعفات إذا فشل استخدام روبوتات جراحية اعتمدت على الميتافيرس، هل سيتحملها الجرَّاح البشري، أم المطورون الذين أنشؤوا الروبوتات الطبية، أم مزودو الخدمات الافتراضية؟ أم غير ذلك؟
رابعًا: التدريب الطبي والتمريض والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل: وذلك باستخدام الميتافيرس في تدريب الأطباء والممارسين الصحيين عبر محاكاة العمليات الطبية المعقَّدة، وتقديم العلاج الطبيعي للمرضى في بيئات افتراضية تُتيح لهم القيام بتمارين بدنيَّة وغير ذلك، بإشراف متخصصين عن بُعد.
ومن بين قضايا هذا المجال: تلك المتعلقة باحتمالية حدوث خطأ أثناء التدريب؛ ومن ثم يُبحَث عمَّن ستقع المسؤولية عليه، هل على الشخص المتدرِّب، أم على المنصة أو الجهة التي أدارت التدريب؟ وأأأأبعد من ذلك، إذا استخدم مريض تقنية الواقع الافتراضي كجزء من العلاج، وتم التعرض للإصابة نتيجة إجراء خاطئ تم تعلُّمه عبر الميتافيرس، من سيُقاضى؟ وأمام أي جهة سيُرفع النزاع؟
خامسًا: تقديم الاستشارات الطبية عن بُعد Telemedicine: وذلك تسهيلًا لتقديم الاستشارات الطبية عبر بيئات افتراضية تتيح للأطباء التفاعل مع المرضى عن بُعد، وهو يُيسر الأمر بلا ريب على كلٍّ منهما، لكن إليك جملة قضايا قانونية محتملة: كتحديد كيفية ضمان حماية خصوصية المرضى، ومحاولة البحث عن الحل القانوني الأولى بالاتباع إذا انتُهكت، وتبعات وأبعاد حدوث أخطاء طبية أثناء استشارة تمَّت عبر الميتافيرس؛ وهل سيُحمَّل الطبيب المسؤولية في حالة عدم فحص المريض بشكل دقيق؟
سادسًا: إجراءات الموافقة المستنيرة (Informed Consent): إذا أُجريت عملية جراحية طبية أو حتى بعض التجارب السريرية باستخدام الميتافيرس؛ فقد تُثار بعض المسائل القانونية، التي من بينها: مدى توفير معلومات كافية للمرضى بشكل واضح لتقديم الموافقة المستنيرة، بل وبافتراض عدم تبصير المريض تبصيرًا كافيًا بالعلاج وبمخاطر العملية الجراحية، أو حتى التجربة السريرية عبر الميتافيرس، من سيُقاضى؟ ومن سيتحمَّل التبعات القانونية عن ذلك؟
سابعًا: إدارة الأزمات والطوارئ الطبية: وذلك باستخدام الميتافيرس لتوفير استجابة سريعة للطوارئ الطبية عبر التواصل مع الأطباء في حالات الطوارئ، وقد أثبتت تقنية الميتافيرس فعاليتها في إجراء جراحات دقيقة في مناطق يصعب الوصول إليها عمليًّا؛ كمناطق الحروب، أو المناطق النائية، كما كانت هذه العمليات أكثر أمانًا؛ بسبب القدرة على استخدام الروبوتات المتقدِّمة لتقليل المخاطر.
ومكمن التساؤلات القانونية في هذا المجال تحديدًا تتصل بمدى ومدة استجابة المتخصصين وتوفرهم، وحدود مسؤولياتهم القانونية، ناهيك عن الحل القانون الأولى بالاتباع إذا كان المريض في مناطق نائية، ولم تتوفر الاستجابة السريعة للطوارئ بسبب خلل في التقنية أو ضعف الاتصال، ومن سيتحمل المسؤوليات المتشعِّبة تجاه تقديم خدمات الرعاية الصحية في حالات الطوارئ؟
ثامنًا: الأخلاقيات في الرعاية الصحية الافتراضية: فإدخال الميتافيرس في هذه الأخلاقيات يردنا لجملة تساؤلات تتعلق بتعامل الأطباء مع المرضى في بيئات غير تقليدية؛ كالسبل القانونية للحصول على الموافقة على العلاج، أو حتى الفحص ما دمنا في بيئة الميتافيرس، وكيف تُقيَّم الأمانة في تقديم التشخيصات والعلاجات عبر منصات الميتافيرس؟
تاسعًا: تطوير الأدوية وطرق العلاجات: ومن ذلك محاكاة الأدوية باستخدام الميتافيرس لتجربة تأثير الأدوية على نماذج افتراضية، وكذا التجارب السريرية المحسَّنة؛ إذ يمكن للمشاركين في التجارب السريرية المشاركة عن بُعد، وهو ما يحقق مزايا عدة؛ كزيادة عدد المشاركين وتسهيل جمع البيانات.
لكن ثمة تساؤلات قد تُثار جرَّاء ذلك؛ من بينها: ماذا لو حدثت إصابة أو أضرار جرَّاء استخدام هذه الأدوية؟ وكيف سيُحدَّد مقدار المسؤولية بافتراض وجودها؟ ومن سينظر النزاع؟ وأي قانون سيُطبَّق من باب أولى على المنازعات سالفة الذكر؟ وهل يوجد تشريع عالمي موحَّد للميتافيرس بالنظر لطبيعتها العابرة للحدود؟
كان ما مضى بيانًا موجزًا لأمرين اثنين: طبيعة مجالات استخدام الميتافيرس في منظومة الرعاية الصحية، تكاتف معه بيان التساؤلات القانونية المترتبة على ذلك، وإن شئت قل: أوجه المنازعات الطبية في البيئة الميتافيرسية، وهي مسائل -على كثرتها وتشعبها- ما زالت مثالًا لا حصرًا؛ والدليل على ذلك: احتمالية حدوث نزاع حول حقوق المرضى في الوصول المتساوي لخدمات الرعاية الصحية؛ لأننا –ببساطة- ما زلنا في رحاب بيئات افتراضية، يمكن أن تنشأ فيها قضايا تتعلق بالتمييز أو التفاوت في الوصول إلى الرعاية الصحية، وهذا وذاك يُعزِّزه اختلاف مكان وجود المريض عن الطبيب، والسير في رحاب بيئة افتراضية.
الرعاية الصحية عبر الإنترنت
وفي ضوء التصور السابق، يبقى السؤال: لمَّا كان الميتافيرس يتيح تقديم الرعاية الصحية عبر الإنترنت من أي مكان في العالم؛ فكيف يكون تحديد المحكمة التي ستنظر المنازعات التي ذكرت أمثلتها -كمسألة أولية- أو حتى القانون الذي سيُطبَّق على هذه المنازعات؟ فهذه وتلك مسائل على تعقيدها، إلَّا أن هناك بعض العوامل أو المؤشرات التي قد تُسهم في معرفة هذا أو ذاك.
فأما عن الجهة التي ستنظر منازعات الميتافيرس الطبية؛ فالأكثر واقعيَّة: أن يكون معظم -وربما كل- أطراف المسألة في أماكن جغرافية مختلفة حول العالم؛ لذا فقد يكون صعبًا تحديد مكانٍ بعينه ليُعقَد له الاختصاص، إلا في حالة توفر أواصر قانونية تُعزِّز من عقد الاختصاص المذكور لجهة بعينها، أو حتى اتفق الأطراف صراحة على سبيل لذلك.
والشيء بالشيء يُذكر، فثمة إمكانية لفضِّ المنازعات المذكورة عبر التحكيم الإلكتروني، بحيث يتم التوصل لحل النزاع دون حاجة لحضورٍ فعلي، وهو ما يُسرِّع بالطبع مسألة الفصل بالنزاع مقارنةً بالسبيل التقليدي لفضها.
ضف إلى ذلك: إمكانية إجراء جلسات محاكمة في بيئات افتراضية؛ ومن ثم يتم تقديم الإجراءات كالأدلة والشهادات أو المستندات عبر تكنولوجيا الواقع الافتراضي، ولربما في المستقبل القريب تظهر أيضًا محاكم الميتافيرس، وحينها يمكن القول وبملء الفم: إنه من الداء يكون الدواء.
أما عن الجانب الثاني المتعلق بالقانون الأولى بالتطبيق على منازعات الميتافيرس الطبية؛ فستخضع بالطبع لما اتَّفَق عليه الأطراف (المريض والطبيب أو المؤسسة الطبية) إذا وجد بينهما ما يفيد الاتفاق على تطبيق قانون بعينه على منازعاتهم؛ فمعلوم أن العقد شريعة المتعاقدين، وعليه إذا لم يُوجد الاتفاق المذكور؛ فسيكون من باب أولى تطبيق القانون الأكثر صلة بالمنازعة، وحسبما تقتضي حيثيات كل منازعة على حدة؛ كأن يُطبَّق قانون الدولة التي حدث فيها العمل الطبي، أو قانون الدولة التي يقيم بها كلٌّ من الأطراف المذكورة.
وعلى صعيد متصل؛ فمَّما تجدر الإشارة إليه: أنه –وحتى لحظة كتابة هذه السطور- لا يوجد قانون عالميٌّ موحَّد يحكم الميتافيرس، وإن وُجِدت بعض المحاولات التشريعية ذات الصلة في عدة دول وولايات سيُشار إليها لاحقًا.
وعليه تقوم بعض الدول بتطبيق –وربما تطويع– قوانينها الموجودة لتُطبَّق على المنازعات الطبية الميتافيرسية؛ كتطبيق التشريعات المتعلقة بـ: حماية الخصوصية والبيانات الشخصية، أو التراخيص الطبية، أو الموافقة المستنيرة، أو أخلاقيات المهنة والمسؤولية الطبية، وهكذا، كلٌّ بحسب طبيعة المسألة المثارة، وفي ضوء مجالات استخدام الميتافيرس في المنظومة الصحية، وكما مضى البيان بداءة.
وهذه النتيجة تأخذنا للزوم الاعتراف بالحاجة لاستحداث أو تعديل التشريعات التي قد تتعامل مع القضايا الطبية الناشئة في البيئة الميتافيرسية، ولحين ذلك.. فطبيعي أن يبقى السؤال قائمًا: هل ستقدم الاقتراحات المعروضة حلولًا عادلة وفعالة؟ ولعل الزمن كفيل بالإجابة الشافية عن ذلك..
وها قد حان مقام استشراف بعض التشريعات المنظِّمة لمسائل الرعاية الصحية عن بُعد حول العالم؛ من ذلك يُذكر -مثالًا لا حصرًا- ما يأتي: وثيقة عمل موظفي المفوضية الأوروبية بشأن مدى تطبيق الإطار القانوني الحالي للاتحاد الأوروبي على خدمات الطب عن بعد، ومشروع قانون ولاية كنساس للتطبيب عن بعد، وقانون ولاية كارولينا الجنوبية لتحديث الرعاية الصحية عن بعد، وقانون التطبيب عن بُعد الماليزي لعام 1997؛ الذي وإن لم ينفَّذ، إلَّا أنه قدَّم تعريفًا مقترحًا لمجمل مفهوم التطبيب عن بُعد، وشموله لأي طريقة لممارسة الطب باستخدام الاتصالات السمعية والبصرية والبيانات.
تجارب الدول الأخرى
ولعلَّ مما يُثري البيان: وقوف الحديث عند بعض التطبيقات العملية حول العالم لاستخدام الميتافيرس في المنظومة الصحية على مختلف التوجهات؛ ومن تجارب الدول الأخرى يُذكر: (1) تجربة مشفى "Mayo Clinic" للتدريب الطبي بالولايات المتحدة؛ ومن ثم إجراء التدريب الجراحي المساعد باستخدام الميتافيرس لتدريب الأطباء والممارسين الصحيين في بيئات آمنة، ومحاكاة العمليات الجراحية المعقدة، كإزالة الأورام أو جراحة الأعصاب دون تعريض المرضى للخطر؛ تقليلًا لفرص حدوث أخطاء في الواقع الطبي، وقد أظهرت الدراسات أنَّ الأطباء الذين تلقوا تدريبًا باستخدام هذه التقنيات كان لديهم قدرة أكبر على إجراء العمليات بنجاح، مع انخفاض معدلات الأخطاء الجراحية.
(2) تجربة مشفى "King's College Hospital" للعلاج النفسي بلندن: وذلك للمرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية، مثل: القلق، أو اضطراب ما بعد الصدمة؛ باستخدام بيئات الميتافيرس، بالتفاعل مع بيئات افتراضية تمثل المواقف التي تثير قلقهم، مثل: الأماكن المغلقة أو الحشود؛ مساعدة للمرضى في مواجهة مخاوفهم في بيئة آمنة تحت إشراف معالجين نفسيين، وقد أسفر عن ذلك تقليل مستويات القلق وتحسين حالاتهم النفسية بشكل فعال.
(3) تجربة مشفى "Cedars-Sinai" بإجراء العمليات الجراحية الروبوتية في الولايات المتحدة بلوس أنجلوس، واستخدام تقنيات الواقع الافتراضي للتحكم في الروبوتات الجراحية الدقيقة عن بُعد، عبر تحكم الجراحين وتوجيههم للحركات التي يمكن القيام بها أثناء العمليات من خلال بيئة افتراضية.
ولمن أراد الاستزادة؛ فهناك أيضًا: تجربتا مشفى Osso VR لمحاكاة الواقع الافتراضي للجراحة بالولايات المتحدة، ومشفى Singapore General Hospital للرعاية الصحية الروبوتية باستخدام الميتافيرس.
توصيات واقعية
وفي الختام، وبعد بيان أوجه دخول الميتافيرس في مفاصل المنظومة الصحية، وبيان دلائل وموضوعات القضايا القانونية المتوقعة، ومواقف الدول حول العالم، ومعه التشريعات المتعلقة الموجودة، وكذا التطبيقات الفعلية في الكيانات الطبية حول العالم؛ يكون من المناسب أن يُختتم هذا الحديث ببعض التوصيات الواقعية:
أولًا: أهمية العمل المتوازي لوضع الأرضية القانونية الرصينة لتنظيم حلولٍ لمنازعات الميتافيرس الطبية، مع استحداث الجهات التنظيمية والإشرافية والرقابية التي يُوكَل إليها مهمَّات إدخال معطيات الميتافيرس في مفاصل المنظومة الصحية بعدالةٍ وتأنٍ وشفافية.
ثانيًا: استحالة إنكار الأهمية الرصينة لاستخدام الميتافيرس في تحسين خدمات القطاع الطبي والرعاية الصحية إجمالًا؛ لكن –في المقابل- ثمة اهتمام مطلوب لإحداث توازن قانوني مُبتغى ما بين قطبي المعادلة: معطيات إدخال التكنولوجيا، ومقومات المنظومة الصحية بأطرها الموضوعية والشخصية.
ثالثًا: وضوح الحاجة لوجود أُطر تشريعية وتوجيهات عالمية أو إقليمية واضحة وملائمة، تضمن الاستخدام الآمن والفعَّال للميتافيرس في القطاع الصحي؛ امتثالًا للتعقيدات الناتجة عن تفاعل أنظمة قانونية مختلفة، فوجود ما ذُكِر يُسهم في إيجاد وتطوير معايير قانونية موحدة لسبل الرعاية الصحية تحت مظلة الميتافيرس؛ ويضمن -في الوقت ذاته- تعزيز التوازن بين حماية حقوق المرضى والأطباء في البيئات الرقمية.
رابعًا: إمكانية عرض المنازعات الطبية المتعلقة بالميتافيرس على محاكم ميتافيرسية (رقمية) تُعنى بالقضايا التي تحدث داخل هذا الفضاء الرقمي؛ فمن الداء يكون الدواء، ناهيك عن فعالية التعاون الحثيث بين الكيانات الصحية ونظيرتها القانونية؛ ليكون العمل متوازيًا يصبُّ في صالح كلا الجانبين: الصحي والقانوني، ويستجيب لمتطلباتهما.
خامسًا: اعتبار الخصوصية، والتراخيص، والمسؤولية الطبية، والموافقة المستنيرة، والأخلاقيات، من أبرز ما يثير التساؤلات القانونية في القطاع الطبي؛ فالتطبيق الكفء للميتافيرس على مفاصل المنظومة الصحية يحتاج لإطار قانوني يستجيب للمعطيات والمعايير الأخلاقية والقانونية.
سادسًا: لا يخفى لزوم تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الإدخال التدريجي للميتافيرس في المنظومة الصحية، وسرد تجارب الأنظمة المقارنة للمرضى؛ دفعًا للخوف المجتمعي، وإشراكًا للمجتمع في الدعم المُقنَّن لدخول الميتافيرس في المنظومة الصحية.
سابعًا: لا ينبغي أن يُغفل الدور المنتظَر للمنظمات الدولية المتخصصة؛ كمنظمة الصحة العالمية في هذا المضمار.
ثامنًا: أهمية فتح الباب للابتكار ودعم جهود الكيانات الصحية والشركات التقنية؛ للعمل معًا لتطوير حلول ميتافيرسية مبتكرة، تُعزِّز الرعاية الصحية بفعالية وعدالة.
تاسعًا: أهمية النظر في التجارب التشريعية للأنظمة المقارنة مما ذُكر؛ ومن ثَمَّ استلهام أفضل ما حوته نصوصها، وتفادي ما لم يَمتثل لذلك؛ كقوانين ولايتي كارولينا الجنوبية وتكساس، وقانون التطبيب عن بعد الماليزي، وغيرهم.
* أستاذ القانون الدولي المساعد كلية الحقوق – جامعة القاهرة.












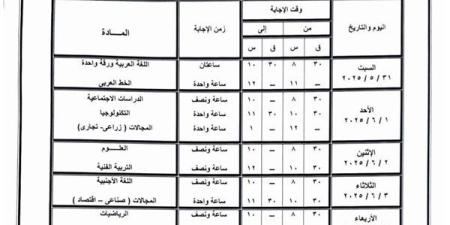
0 تعليق